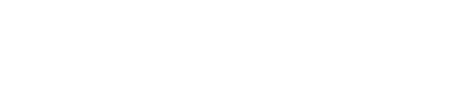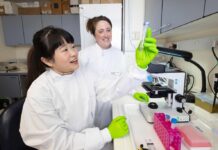يقال إن المشاكل الكبيرة تحتاج إلى حلول كبيرة، وهذا ما ينطبق بالفعل على أغلب المشكلات البيئية التي يعاني منها حاليا كوكبنا البائس، وخاصة ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض المعروفة باسم الاحتباس الحراري.
وتفاقمت هذه الظاهرة وزادت حدتها بشدة خلال العقدين الماضيين إلى حد فرض مخاطر مستقبلية حقيقية على الأجيال القادمة، ليس أقلها تهديد المجتمعات الساحلية بالغرق ومناطق عمرانية كثيرة بالزوال.
وقد تتابعت تحذيرات العلماء المتخصصين وجماعات حماية البيئة والهيئات الأممية المعنية، وآخرها تقرير اللجنة الدولية للتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة الصادر هذا العام والذي أكد على دور الإنسان والأنشطة البشرية بوجه عام في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
كما حذر من أن استمرار الوضع بهذا الشكل يمكن أن يتسبب في هلاك ملايين البشر نتيجة التداعيات المستقبلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر وتسارع ذوبان المناطق الجليدية وعن زيادة وتيرة الفيضانات والعواصف وغيرها مما يعزى إلى تغير أو تطرف طبيعة المناخ العالمي.
المحاولات الأولى
وإثر هذه التحذيرات تعددت الجهود الوقائية والمحاولات الفردية والجماعية الرامية إلى الحد من ارتفاع الحرارة ووقف تلك الظاهرة بينها محاولة عقد اتفاقيات دولية للحد من الانبعاثات الغازية وابتكار طرق إنتاج مواد صديقة للبيئة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر وغير ذلك من السبل التي تعتمد على مبدأ التخفيف من آثار التغير المناخي أو التكيف معها.
لكن يبدو أن هذه السبل لم تكن مؤثرة بالقدر الكافي إذ لم ينجح أي منها في كبح جماح ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
لذا لجأ مؤخرا نفر من العلماء إلى منحى علمي آخر وأسلوب مبتكر لعلاج تلك المشكلة يتمثل في هندسة المناخ أو الهندسة الأرضية، أي محاولة تغيير أو تلطيف أو تبريد المناخ ودرجة الحرارة على سطح الأرض محليا أو إقليميا سواء كان هذا بالتدخل في حركة السحب السائدة أو شدة أشعة الشمس المنبعثة أو كميات الأمطار المتساقطة أو توزيع النباتات والطحالب التي لها القدرة على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، أو غيرها من العوامل والمكونات الفاعلة في ضبط درجة الحرارة على سطح الأرض.
والأمر على هذا النحو يشبه تماما، من حيث الفكرة، ما نعاصرُه ونراه منذ زمن أثناء موسم الحج بمكة المكرمة من نثر رذاذ الماء وبخار المياه بصفة مستمرة من أنابيب ومظلات مرتفعة مخصصة لهذا الغرض بغية خفض درجة الحرارة وطبيعة الجو السائد في نطاق دائرة القطرات المرطبة المتناثرة والتخفيف بالتالي من أثر الطقس القاسي على الحجيج.
ومن الوسائل الأخرى المعروفة التي يمكن بواسطتها هندسة المناخ في منطقة ما، تقنية استمطار السحب، التي تتم عن طريق نثر أتربة أو مواد محفزة وسط السحب بواسطة الطائرات أو البالونات الهوائية، وهذا من أجل استثارة هذه السحب وحثها على إلقاء حمولتها من بخار المياه في صورة أمطار.
وقد جرى بالفعل تطبيق هذه الطريقة في الصين على نطاق واسع وفي بعض الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج العربي، وإن لم تحقق النجاح المأمول.
أفكار جديدة ومبتكرة
وفضلا عن الطرق النمطية السابقة، هناك أيضا طرق جديدة ومبتكرة لهندسة المناخ والحد من ارتفاع درجة الحرارة تختلف كليا في المقياس وأسلوب التطبيق والنتائج المترتبة عن الأمثلة النمطية المذكورة آنفا.
وهذه الطرق تعتمد في الأساس إما على استخلاص وامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو، وإما على التقليل من الأشعة والحرارة الشمسية الصادرة نحو سطح الأرض.
وهناك أفكار وسبل كثيرة ومتنوعة جار تجربتها لتحقيق هذا الغرض، من بينها -مثلا- محاولة محاكاة التأثيرات الطبيعية للبراكين الكبيرة ودور الأبخرة والأتربة التي تنطلق بكثافة منها في خفض درجة الحرارة على سطح الأرض، وهي الطريقة التي تعرف باسم “البراكين الصناعية”.
وتقوم هذه الطريقة على نثر كميات كبيرة من جزيئات وأملاح الكبريتات الدقيقة بواسطة الطائرات أو الصواريخ داخل طبقات الجو العليا وتحديدا طبقة “الستراتوسفير” من أجل خلق غيوم معتمة تعمل على حجب الضوء وتشتيت أشعة الشمس قليلا وخفض درجة الحرارة على السطح.
كما تم تطبيق طريقة جديدة تعتمد على سحب واستخلاص غاز ثاني أكسد الكربون من الجو بطريقة صناعية وتخزينه في الغابات أو ضخه إلى الأعماق السحيقة للبحار والمحيطات.
ومن الأفكار المطروحة أيضا محاولة عمل سحب صناعية عن طريق محاكاة عملية التبخر الجوي التي تجري في البحار والمحيطات بشكل مستمر عن طريق سحب كميات هائلة من مياه البحر من سطح المحيط وضخها لأعلى في هيئة رذاذ متناثر مما ينتج عنه تكوين سحب منخفضة وحجب لأشعة الشمس.
وتجرت أيضا محاولات لتسميد مياه المحيطات وزيادة خصوبة المياه السطحية فيها من خلال نشر كميات كبيرة من برادة الحديد أو الفسفور أو الأملاح المغذية على مساحات كبيرة من البحار أو المحيطات من أجل تحفيز نمو الطحالب والعوالق النباتية الهائمة التي تقوم بدورها بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل روتيني ضمن عملية البناء الضوئي.
وهناك طريقة جديدة لا تخلو من طرافة وتفرد تعتمد على نشر مرايا عملاقة على ارتفاع كبير من سطح الأرض بغرض عكس أشعة الشمس المنبعثة نحو الأرض وتلافي عملية التسخين الحراري التي تقوم بها.
المنافع والمخاطر
هناك بلا شك مزايا ومنافع عديدة يمكن أن تتحقق في حالة نجاح أي من تقنيات هندسة المناخ الجديدة المذكورة آنفا وتطبيقها على نطاق واسع.
وفضلا عن دورها في تعديل المناخ في منطقة جغرافية ما والحد من ارتفاع درجة الحرارة فيها، فهي يمكن أن تساهم أيضا في زيادة الإنتاج الزراعي والتقليل من حدة المجاعات وحرائق الغابات والأعاصير الموسمية والتقليل كذلك من الوفيات البشرية الناتجة عن هذه الحوادث وعن الموجات الجوية الحارة خلال موسم الصيف.
ويمكن أن تساهم هذه التقنيات في علاج بعض المشاكل البيئية الأخرى خاصة مشكلة الأمطار الحمضية وزيادة حموضة البحار والمحيطات وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وغيرها من المشكلات الناتجة عن زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو.
يشار أيضا إلى أن التكلفة المادية لهذه التقنيات رغم ارتفاعها نسبيا فإنها تظل معقولة ومحتملة خاصة إذا ما قورنت بإجمالي تكلفة سياسات خفض الانبعاثات الغازية المتخذة على مستوى العالم وبقية الإجراءات الوقائية ووسائل التكيف مع مخاطر التغير المناخي التي تقدرها إحدى الدراسات الحديثة بحوالي 200 مليار دولار سنويا.
في المقابل، توجد عيوب وسلبيات يمكن أن تظهر في حال تطبيق تقنيات تعديل المناخ السابقة أو الهندسة الأرضية بصفة عامة.
فمن حيث المبدأ، يتعارض تطبيق أغلب هذه التقنيات مع بعض القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية المعترف بها من ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي التي تمت إضافة بند جديد إليها في العام 2010 ينص على “منع جميع الأنشطة المتعلقة بهندسة المناخ التي يمكن أن تؤثر على التنوع الأحيائي، وتستثنى التجارب والأبحاث العلمية التجريبية التي يمكن تطبيقها بشكل محدود وعلى نطاق ضيق”.
ويجب الانتباه إلى أن معظم هذه التقنيات ما زالت قيد التطوير والتجريب ولا يتوقع اعتمادها قبل عشرة أعوام وربما 20 عاما من الآن.
وبديهي أنه خلال هذه الفترة يمكن أن تحدث طفرة أو قفزة علمية مثلا في تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية أو تصنيعها وهي من المصادر الواعدة والنظيفة أو غيرها من المواد والمصادر غير الضارة بالبيئة التي لا ينتج عنها إطلاق الغازات الدفيئة مثل النفط وبقية أنواع الوقود الأحفوري.
وفضلا عن ذلك، فإن التكلفة المادية لهذه التقنيات تعتبر مرتفعة نسبيا ولا تستطيع تحملها سوى الدول الصناعية المتقدمة، وهذه التكلفة وإن ظلت أقل كثيرا من التكلفة الإجمالية للإجراءات والسياسات الوقائية المتخذة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري ومخاطرها، إلا أنها تعتبر فوق طاقة الدول النامية والفقيرة، وهو ما يعني اقتصار فوائد تلك التقنيات ومزاياها على الدول المتقدمة دون غيرها.
ويجب الالتفات إلى أن تطبيق هذه التقنيات يمكن أن يتسبب في بعض الآثار والمشاكل البيئية الجانبية غير المرغوبة، فنثر جزئيات الكبريتات في طبقة الستراتوسفير يمكن أن يؤدي إلى زيادة تآكل طبقة الأوزون وزيادة تعرض السكان لاسيما في نصف الكرة الجنوبي للأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وبالمثل فإن تسميد مياه البحار والمحيطات يمكن أن يؤدي إلى زيادة العوالق والهائمات النباتية بشكل فائق وزائد عن الحد، مما قد ينتج عنه نفوق أعداد هائلة من الأسماك والكائنات البحرية بسبب الاختناق وقلة الأكسجين.
نافلة القول إن التقنيات الجديدة المتعلقة بهندسة المناخ شأنها شأن معظم المستجدات والمخترعات العلمية المستحدثة لا تزال في طور التجريب والتطوير، ولا يزال من المبكر جدا الحكم عليها وعلى جدواها وفاعليتها في تحقيق الغرض الذي تصبو إليه وحل المشكلات البيئية التي يعاني منها كوكب الأرض وساكنوه حاليا.
لكن هذا لا يمنع من القول إن هذه التقنيات تبدو في المرحلة الحالية أقرب للخيال العلمي من كونها منجزات علمية واقعية، وإن وجب لفت انتباه القراء والمتابعين إلى أن عددا كبيرا من الاختراعات والإنجازات العلمية الحالية بدأت في الأصل بخيال علمي واسع من أحد العلماء أو الكتاب، واسألوا في هذا الصدد الكاتب الإنجليزي هربرت جورج ويلز المولود في العام 1866 عن اختراع الطائرات.
الباحث: وحيد محمد مفضل
باحث مصري حاصل على الدكتوراه في الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد
المصدر : الجزيرة